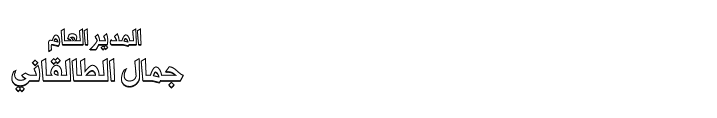بقلم : فالح حسون الدراجي …
أكتب هذا المقال، لأضع النقاط على حروف علاقتي مع الشاعر الكبير عريان السيد خلف، تلك الحروف التي ظلت لفترة طويلة بلا نقاط، فكاد معناها يتغير، ويمحى، حتى ظن البعض أن هذه الحروف ستبقى هكذا الى الأبد..
إن علاقتي بالكبير عريان السيد خلف قديمة جداً، تناهز الخمسين عاما، أي منذ ان تعارفنا عن طريق الشاعر الكبير كاظم اسماعيل الگاطع.
وعلاقتي بأبي خلدون، لم تتوقف عند محطة الشعر فقط، إنما أخذت مسارات شعرية وسياسية وعائلية واجتماعية عديدة، حتى نمت هذه العلاقة وكبرت، وتجذرت في الاعماق، فبات قلعها مستحيلاً !
ومثل أي علاقة تعمّر كل هذه العقود، وتمضي كل هذه المسافة الطويلة، تتعرض لبعض المطبات الطبيعية، والاصطناعية التي اشتغل البعض بهمّة على وضعها، خصوصاً وأن التاريخ يذكرنا بأمثلة عن أن العلاقة بين شاعرين يمارسان لعبة الشعر في ساحة واحدة، تكون عرضة للشد والجذب، وللضرب تحت الحزام من أشخاص لا يريدون لهذه العلاقة أن تبقى.
لذا لا أكشف سراً لو قلت، إن ثمة (زعل) قد حدث بيننا فعلاً، وبعض البرود أصاب علاقتنا أيضاً، لكن زعلنا لم يصل العداء، أو حد الكراهة، أو البغضاء لاسمح الله. كيف أكون عدواً لشاعر مثل عريان، شاعر أطرب الشعر قبل أن يطربنا بروائعه وشاعريته الفذة، وأسكر الزمان بخمر قصائده وعذوبة أغنياته التي لا تنسى.. وهل ننسى : (تلولحي بروحي گصيبة تلولحي، وتمرجحي بگلبي قصيدة تمرجحي ..
احنه خلانه وكتنا تراب بحلوگ الرحي .. شما يطول الجرح بينا يطيب بس ما يمنحي .. تلولحي)!
وكيف أبغض شاعراً، سرت معه على ذات الطريق المزروع بالجمر والدمع والمواجع؟
ومن منا لا يعشق شاعراً زرع لنا كل هذه الدهشة، وهذا الجمال، فامتلأت بيادرنا بسنابل الشعر، وأزهار الحب الآذارية، حتى أضحى عريان بموهبته الذهبية، شاعرنا الألمع، والأعلى سطوعاً في سماء الإبداع؟
كيف أكره سنداً مثله، وأنا أحد الذين احتموا يوماً بعنفوان اسمه، واتكؤوا على جدار شموخه، حين كانت أعوادنا طرية في السياسة والشعر والحياة؟
وللحق، فإن عريان أحبني كما أحببته أخاً وصديقاً ورفيقاً، وأظن أن الصورة التي أمامكم كافية للتعبير عن المودة والأخوة التي كانت بيننا. فهذه الصورة التي التقطت قبل أكثر من ثلاثين عاماً، والتي تجمعني بالراحل عريان، والإعلامي الكبير حسام حسن، تغني عن شرح ألف مقال .
وهنا يجب أن أقول، إن أبا خلدون عاملني معاملة الشاعر للشاعر، مذ كنت في أول الطريق الشعري، ورغم الفرق الكبير الذي كان بين تجربتي البسيطة، وتجربته الشعرية العالية..
وأذكر ذلك الحفل الذي أقامته منظمة الحزب الشيوعي في الرميثة العام 1974، بمناسبة الذكرى الأربعين لميلاد الحزب، حيث أقيم في مضيف كبير، مشيّد من القصب والحصران، ومزين بصور المؤسس فهد، وباللافتات والشعارات الشيوعية، وكانت الدعوة قد وجهت لأبي خلدون للمشاركة في هذا الحفل، على أن يختار معه شاعراً واحداً لا غير، فاختارني رفيقاً له في هذا الاحتفال الذي تواصلت فقراته الغنائية والشعرية حتى طلوع الفجر، وقد القيت فيه ثلاث قصائد، نالت اعجاب المحتفلين .. وحين سألوا عريان عن سبب اختياره لي دون غيري، أجابهم: إن (فالح شاعر شاب موهوب، له مستقبل شعري كبير، لذا أردتكم ان تسمعوه).
ولعل من حسن حظي أن أحتفظ ببعض الصور لتلك الحفلة، التي جلبها لنا أحد المعلمين الشيوعيين الذين كانوا يدرسون في الرميثة، ويسكنون الثورة.
لقد كان أبو خلدون يثق برأيي، حتى انه زارني في البيت ليلاً، وقرأ لي قصيدة (گبل ليلة) وهي (حارة)، إذ كتبها قبل ساعة فقط، وجاء لأقول له رأيي بهذه القصيدة، فهو يعرف جيداً أني لا أجامل في الشعر قط، وحين سمعتها، قلت له (بصراحة، إنها أفضل قصيدة في تاريخ شعريتك الطويل)!
أذكر مرة قال لي: يعجبني فيك يافالح، أنك لا تعامل أصدقاءك بالمثل عند إساءتهم لك، وهذه صفة لا يتصف بها إلا القليلون.
وبكل تواضع اؤيده وأقول: نعم، فقد غضضت الطرف مرات عدة عن اساءات الأصدقاء، وتجاوزت الكثير منها، فأنا رغم شراستي في مواقفي ومقالاتي تجاه اساءات الأعداء والخصوم تراني مسالماً مسامحاً ليناً في مواجهة الاساءات التي تصدر أحياناً من أصدقائي، لأني اؤمن أن الصديق هبة من هبات الطبيعة، وهدية قدرية، لايجوز التفريط بها
لذلك يقول لي الصديق والزميل علاء الماجد: (أنت مسامح كريم جداً). ونفس الكلام أو ما يشبهه يقوله عني بعض الزملاء، والأحبة، وأنا فخور بهذا، وفخور جداً لأني لم أقل أو أكتب يوماً حرفاً جارحاً بحق صديق طيلة حياتي، وسأمضي لقبري سعيداً، لأني لم أخدش مشاعر، أو أجرح كرامة صديق واحد حتى لو ظلمني، أو أساء لي هذا الصديق، فأنا أعتبر كرامة الصديق، كرامتي، وأي ثلم أو انتقاص منها، هو انتقاص وثلم لكرامتي، هكذا أنظر لأصدقائي..!
لذلك رفضت كل الدعوات التي وصلتني كي أرد على أبي خلدون، حين أجاب عن سؤال وجهه له مقدم أحد البرامج، قائلاً عني: (كان صديقي)! ثم قرأ بيتاً لاعلاقة له بالموضوع قط.
ورغم أني لم أغلط معه، أو أخطأ بحقه يوماً، إنما حدث سوء فهم بسيط، في أمسية شعرية أقيمت له في أمريكا، وقد حضرت تلك الأمسية رغم ارتباطي بموعد مهم جداً، ثم غادرت القاعة بعد ساعة من بدء الأمسية، لكن أبا خلدون زعل عليّ، معتقداً أن خروجي كان نفوراً، أو رفضاً لأمسيته، أو شيئاً من هذا النوع.. ولا اعرف إن كان في العراق-من شماله الى جنوبه-، شخص واحد ينفر من شعر عريان السيد خلف أو من القائه الساحر كي أضجر أنا منه؟
وطبعاً فإني لم أرد على ما قاله عني أبو خلدون في ذلك البرنامج، رغم أن ثمة قنوات عديدة عرضت عليّ بل وألحت أن تستضيفني على شاشاتها لأرد على ما قاله بصددي، بما في ذلك القناة بل والبرنامج الذي استضافه ذاته! إنما كنت أجيب الجميع برد واحد: (أبو خلدون لم يقل شيئاً سيئاً عني لأرد عليه، فضلاً عن أنه معلمي، فهل يرد التلميذ على معلمه؟
اقول ذلك والجميع يعرف أن عريان لم يكن معلمي في الشعر، فأنا أنتمي الى مدرسة – إذا صح التعبير- غير مدرسة، ومنهج ولغة، واسلوب عريان الشعري. لقد رفضت الدعوات وكل الضغوط، ولم أرد على أبي خلدون، إنما اكتفيت بزعل سري بسيط بيني وبينه! فقد كان يعرف أني أحبه -رغم القطيعة التي حدثت بيننا- وأني احترم شعره جداً، واعترف أني قلت مرة (انا مستعد بأن أتخلى عن كل شعري مقابل بيت شعر لعريان قال فيه: (تمنيتك تجي بكد ما تمنيت .. حتى انشدك من عطشتك ليش ما جيت).. أو البيت الذي يقول فيه: ( الليل لو سد الروازين .. شمسين حمرة يخضر الطين )!
واليوم أقولها بملء فمي، وهو في غيابه الموحش: إن عريان أكبر من الشعر، ومن الخصومات والزعل.. أما أنا، فلن أسامح نفسي أبداً، لأني لم أزره بمحنته، ولم أذهب الى مشفاه لأقبل جبينه الوضاء العالي وأودعه وداع الأخ لأخيه قبل رحيله، لذلك بكيت بكاءً مراً حين سمعت خبر وفاته، وجئت دامعاً الى موقع مجلس الفاتحة المقام على روحه. فاحتضنت نجله العزيز ( خلدون) وصرخنا معاً، ثم التفتّ الى صورته المتشحة بالسواد، وقلت بصوت عالٍ امام الجميع:
وداعاً أيها الشاعر الذي لم تنجب الطبيعة جبلاً مثله